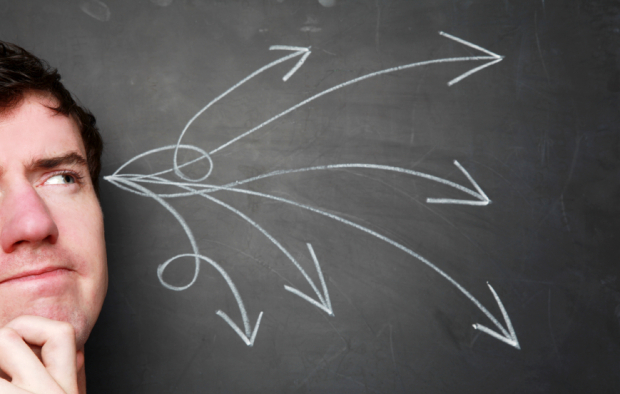السجون اللذيذة

“عقل المتعصب كحدقة العين، كلما تعرضت لمزيد من الضوء، زاد انقباضها”[1] ، كثير من العقول عندما تتعرض لأنوار الحقائق، تعطل أدواتها في الفهم، وتلجأ إلى الأفكار الجامدة المغلقة، لتفهم ما يدور حولها، وإذا تعرض الإنسان لعمليات “غسيل مخ”، فإنه يسجن نفسه في أفكار بعينها، ولا يخرج منها.
في كتاب “سجون نختار أن نحيا فيها” تتحدث “دوريس ليسنج” الأديبة البريطانية الحائزة على جائزة “نوبل” عن ثلاث عمليات تتعرض الأمخاخ معها للغسل، أو الإخضاع، وهي: التوتر الذي يعقبه الاسترخاء، والتكرار، ثم الشعارات، أي اختزال الأفكار مركبة إلى مجموعة بسيطة من الكلمات.
وربما هذا ما جسده الفيلم الأمريكي (American Pastoral) الذي يحكي تأثير الانتماء لأفكار مغلقة وتنظيمات سرية على عقول الأفراد، إذ تُغسل تلك العقول غسلا، ويُعاد تركيبها من جديد، بعد تغيير منظومتها القيمية، فيدخل هؤلاء في سجون أفكارهم راضين، ولا يسعون للهروب منها، فالفتاة الصغير والأرستقراطية “ميرى” التي انتمت إلى تنظيمات يسارية أمريكية في حقبة الستينات، تحولت من إنسانة وديعة إلى شخصية أخرى؛ فتقتل بدم بارد، لتتعرض لملاحقات الشرطة، فتتخفي، وهناك في عالم الظل المخيف تتعرض للاغتصاب من رفاقها، فتترك أفكارها اليسارية لتعتنق أفكارا تمزج بين البوذية والهندوسية، لتعيش “ميري” في سجن جديد أكثر انغلاقا، وتمضي أحداث الفيلم لتكشف بشاعة الأفكار عندما في تجد في العقل فراغا تبني فيه أعشاشها مهما كانت زيفها، فتسد مسامع الإدراك، والعقل هو أعظم ما يبصر به الإنسان.
خبرة الحياة تهتف دوما عن تقلب رؤى الإنسان دوما، فالأفكار لا تعيش طويلا، فما يحسبه الإنسان يقينا في فترة ما، يكتشف بعد فترة أنه كان ضربا من الظنون، والمبادئ التي كان يُظن أنها معصومة، اتضح أنها زيف ووهم، وكثير من التضحيات التي دفعت عن إيمان راسخ، يجد المرء أنها كانت هباء، وكثير من الأفكار التي آمن بها الإنسان في صباه يضحك عليها ومنها في أحسن الأحوال عندما يمضي به العمر، أما إن كان من التعساء، وارتكب الحماقات بدوافع من أفكاره فإنه يعيش أزمة مخيفة، إذ يعيش في سجني الفكرة والحماقة..لا يستطيع أن يترك فكرته..ولا ينسى المجتمع له حماقته، وكثير من المجتمعات لا تعرف المغفرة.
لذلك كان الفيلسوف البريطاني ” برتراند راسل” يرى أن “مشكلة العالم هي أن الأغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائما، أما الحكماء فتملأهم الشكوك” ولذا أقترح تدميرا مبكرا للقناعات الواهية من خلال أن يأتي بأشد المتعصبين من كل فكرة ومذهب ليعرضوا أفكارهم على الطلاب الصغار، فيتنقل هؤلاء الصغار مبكرا بين القناعات المختلفة وبين الحجة ونقيضها ليصلوا في نهاية المطاف برفض مطلق بأن يكونوا حبيسي فكرة ما، أو أسيري أيديولوجية معينة، لتصبح حياتهم مثل الطائر الذكي الذي ينظر إلى الحبوب في شباك الصيد فينزل فليتقطها ويطير مسرعا حتى لا يصبح فريسة لتلك الشباك.
ولعل أبشع سجون الأفكار أن تحبس الأفراد والمجتمعات نفسها في الأنا المتعالية..ذلك السجن الذي يصور للإنسان والمجتمع أنه فوق الجميع، وأنه مختلف عن الناس، وأنه ليس من الطين، تلك الأنا التي حدثنا عنها القرآن في قول غلاة اليهود “نحن أبناء الله وأحباؤه“، وأن لهم الجنات في الآخرة من دون الناس؛ تلك الفكرة الحابسة تكررت في التاريخ ومن أهل الأديان وفجرت من الدماء البريئة أنهارا، فهتلر أعلن “ألمانيا فوق الجميع…وأنه على استعداد لحرق العالم بأسره كي يبقى الشعب الألماني مرفوع الرأس” فكرة متعالية كلفت العالم أكثر من خمسين مليون قتيل.
ومن يقرأ السنة النبوية يلحظ بوضوح أن السماء كانت توجه المسلمين دوما إلى الخروج من سجون الأفكار لأنها مُهلكة للدعوات العظيمة، فعندما قتلت قبائل “عضل والقارة” سبعين من خيرة الصحابة غدرا ، ظل النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، يدعو عليهم شهرا كاملا، حتى نزل قوله تعالى:”ليس لك من الأمر شيء“.. لقد أخرجت الآية الكريمة المجتمع المسلم من فكرة الانتقام والكراهية إلى رحابة التسامح والعفو.
الفضاء الإنساني الذي يبنيه الإسلام يسع الناس جميعا؛ لذا عندما دخل محمد، صلى الله عليه وسلم، مكة يوم الفتح كان متواضعا متحررا من الأفكار الانتقامية، ومن أمراض الكراهية، ليعلن أمام من حاربوه وآذوه وأخرجوه من دياره: اذهبوا فأنتم الطلقاء..اليوم يوم المرحمة”..كان خروجا عظيما فتح الآفاق والأنفس وحطم أسوار السجون الفكرية وأتاح للنور أن يطرد الظلمة والظلم..على خلاف سيطرة فكرة الانتقام على الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، فحدثت عام 1945 أكبر عملية اغتصاب في التاريخ الحديث في العاصمة النمساوية فينا، حيث اغتصبت أكثر من مائة ألف امرأة.
ومن أعظم مسجوني الأفكار التي سجلها التاريخ الإسلامي “الخوارج” الذين كانوا عظيمي البكاء والخشوع لكن وضعوا أنفسهم في عقول مؤصدة، ذات قرار بعيد، ومفاتيح ضائعة فشقوا وأشقوا الآخرين، وفي تاريخ الدولة الأموية وحدها قاموا بحوالي (23) ثورة ، وقد لخص ببراعة العلامة محمد أبو زهرة حالهم بقوله: “وأنهم ليشبهون في استحواذ الألفاظ البراقة على عقولهم ومداركهم اليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع في الثورة الفرنسية فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والإخاء والمساواة وباسمها قتلوا الناس وأهرقوا الدماء” .
وهيمنة السجون الفكرية على الباحث، تجعله يضل عن الوصول للحقائق، وتمنعه من أن تكون نتائج أبحاثه متصفة بالعلمية والموضوعية والحيادية، ذلك أن الأيديولوجية تقود الباحث، وتسوقه دائما إلى مواقف ونتائج محددة سلفا، لأنه يسعى إلى تغيير العالم لا تفسيره، وقد سيطرت على العقل الغربي فكرة بحر الظلمات وتصوروا أن المحيط الأطلسي هو نهاية اليابسة وأن الشمس عندما تغيب تستقر هناك، وعندما تخلص الغربي من تلك الفكرة بدأت حركة الكشوف الجغرافية التي غيرت تاريخ الإنسان في القرون الأخيرة.
وعلى الجانب الإسلامي تعددت سجون الأفكار التي دفعت أصحابها إلى خوض عشرات المعارك الخطأ، وفي التوقيت القاتل، فكانت الخسائر فادحة والنتائج هزيلة، وعندما جاءت بعض المراجعات الشجاعة كان الوقت قد نفذ، والفرصة قد رحلت.
لكن كيف نخرج من سجن الأفكار؟..
في تصوري أن العدل هو أول مفاتيح الخروج ، مفتاح تنبه إليه قديما الصحابي “ربعي بن عامر” عندما قال:جئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام” والجور هنا هو أسر مقولات معينة على تفكير الناس تحرمهم من أن يكونوا عدولا ” اعدلوا هو أقرب للتقوى” .
أما الإنسانية فهي المفتاح الثاني، لابد من الإيمان بقضية الإنسان فكما يقول الإمام علي:”الناس صنفان أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق” فهؤلاء المحبوسون في أفكارهم يحولون الآخرين إلى أشياء أي ينفون عنهم الإنسانية والكرامة، وبالتالي يستحلون دمائهم وأعراضهم وكرامتهم، ففرعون ذبح ذكور بني إسرائيل لأنه حولهم في اعتقاده إلى حيوانات وليسوا بشرا موفوري الكرامة.
ومن يراجع تاريخ التقسيم الإسلامي للعالم يلحظ أن بعض المقولات حبست العقل المسلم في أماكن احتجاز ضيقة من قبيل:”دار الإسلام ودار الكفر” دار السلم ودار الحرب..حتى جاءت مقولات أخرى حررت العقل بتقسيم العالم إلى “أمة الإجابة وأمة الدعوة” أي أن هناك أمة عليها مسؤولية أخلاقية عظيمة في هذا العالم تجاه بني البشر، وتلك الرؤية أكثر انفتاحا وإنسانية من الرؤى السابقة..
ولم يكن العقل المسلم وحدة هو حبيس تلك الأفكار فالعقل الأوروبي جرت سجون أفكاره على العالم وبالا كبيرا ولعل أبرزها :عبء الرجل الأبيض” والتي كانت سجنا فكريا للعالم وللعقل الغربي أوقع مظالم كبيرة بأهل الأرض..
يقول مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم:”أشد سجون الحياة فكرة خائبة يُسجن الحي فيها، لا هو مستطيع أن يدعها، ولا هو قادر أن يحققها؛ فهذا يمتد شقاؤه ما يمتد ولا يزال كأنه على أوله لا يتقدم إلى نهاية؛ ويتألم ما يتألم ولا تزال تشعره الحياة أن كل ما فات من العذاب إنما هو بَدْء العذاب.”
وياليت هؤلاء يستمعون إلى نصيحة الأديب اللبناني “ميخائيل نعيمة” في كتابه “البيادر”: “ألا فتشوا مذهبكم بإخلاص، فتشوها بلهفة العاشق، فتشوها بطهارة الطفل، وحرقة التائة، وإيمان المحتظر، تجدوا فيها السلام، الذي تطمحون إليه، والطمأنينة التي تحلمون بها، والحرية التي باسمها تترنمون”.
[1] مقولة للأديب الأمريكي “أوليفر وندل هولمز”
مصطفى عاشور